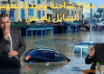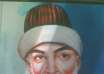بقلم محمد زُعَيْر
 تتميز الثقافة الشعبية المغربية بتنوع روافدها الاجتماعية ، و المتأمل في النسيج الاجتماعي يكتشف أن المغاربة خليط من عرب وافدين من المشرق ، و أمازيغ اعتنقوا الإسلام إبان الفتوحات الإسلامية ، وأندلسيين استوطنوا شمال المغرب بعد سقوط الأندلس ، و صحراويين .
تتميز الثقافة الشعبية المغربية بتنوع روافدها الاجتماعية ، و المتأمل في النسيج الاجتماعي يكتشف أن المغاربة خليط من عرب وافدين من المشرق ، و أمازيغ اعتنقوا الإسلام إبان الفتوحات الإسلامية ، وأندلسيين استوطنوا شمال المغرب بعد سقوط الأندلس ، و صحراويين .
ورغم هذا التنوع البشري إلا أن الشخصية المغربية احتفظت بمشخصاتها الوطنية عبر التاريخ ، وجعلت غير المغاربة ممن وفدوا إلى المغرب و استقروا فيه يتمغربون أي يكتسبون العقلية و الذهنية المغربية .
لقد كان لهذا التنوع البشري مترتبات دينية و ثقافية و فنية و اجتماعية وسياسية حتى قال شاعرهم محمد الحلوي رحمه الله :
لَسْتَ تَلْقَى كَالْــــــمَغْرِبِ الْفَذِّ أَرْضا
وَلَوْ اجْتَزْتَ الْأَرْضَ طُولاً و عَرْضاً
ذِي بِـــــــــلادِي يَنْهالُ مِنْها اعْـــــتـــــــــِزازِي
نَـــــابِــــــضٌ حُـــبُّهَا مَعَ الـــــرُّوحِ نَـــــبـْضاً
و لا ريب أن هذا التنوع جعل المغرب فذا ، متميزا ، شامخا بخصوصياته ، معتدا بثقافته ، تلك الثقافة التي تعتز بعروبتها الممتدة إلى المشرق العربي، و أمازيغيتها المتغلغلة في ربوع الأطلس الشامخ بجباله و قبل ذلك و بعده بإسلاميتها ،
إن الذاكرة الشعبية المغربية مثلها مثل نظيراتها عند سائر شعوب العالم ، حبلى بالأمثال و الحكم ، وقد جرت على ألسنة المغاربة أمثال وحكم تنهل من نبع حياتهم الفياض و تغتذي من صميم واقعهم الثر المتعدد، وغدت تعبيراتٍ سائرةً ، تتميز بتصوير مواقف شتى في إيجاز يجمع بين سلامة الفكرة وقوة التعبير و صدقه ، و هي بذلك تختصر خبرة مبدعها بالحياة ، و لا ريب أن ذلك يُعْزى إلى أنها لم تصدر من أفواه السُّذَّج الغُفَّلِ ، الذين ما خبروا الحياة و لا عركتهم تصاريفها ، و لكنها صدرت عن أشخاص تمرسوا بالحياة فصقلتهم و أخرجت أروع و أجمل ما فيهم .
وكشأن سائر الأمثال و الحكم في شتى ثقافات العالم ، فإنها تخرج من رحم التجربة لا يُعْلَمُ لها صاحب ، فهي ابنة المجتمع و سليلته ، وضعتها التجربة بعد مخاض و تلقفتها الآذان و صقلتها الأيام ، فامتزجت بدماء الروح و تبوأت من القلب سويداءه . تتماثل تارة و تتعارض أخرى ، حتى ليخيل إليك أن ثقافتنا تؤمن بالشيء و نقيضه في الآن نفسه ، و هي في تماثلها و تعارضها تنفصل عن سياق إنتاجها لتنخرط في سياقات أخرى ، مقدمة نفسها في صورة الناصح الأمين و المعلم المشفق و المربي .
وحتى لا يطول بنا الحديث عن الأمثال و الحكم و هو ما أغنت عنه كتب قديمة و حديثة حفلت بتعريفها و بيان خصائصها و الحكمة منها ، أضع بين يدي القارئ نموذجين من الأمثال و الحكم باللهجة المغربية ، و أنا أدرك تماما الإدراك ما قد يجده غير المغربي من صعوبة في فهم هذه اللهجة ، حتى ليخيل لأحدهم أننا نتكلم لغة عامية لا صلة لها باللغة العربية ، و في هذه العجالة سنعمل على تجلية ما قد أشكل من معانيهما مبرزين خصائها الفنية و الجمالية ما استطعنا إلى ذلك سبيلا . ودونكم هذين النموذجين :
- النموذج الأول : ” كُونْ كانْ الخوخْ يٍداوي كُونْ دَاوَى راسو”
هذا مثل مغربي أصيل تجري به ألسنة المغاربة ، و ترجمته الحرفية هي ” لو كانت فاكهة الخوخ تعالج لعالجت نفسها ” . و لعل أقرب مثل إلى هذا المثل المغربي هو المثل المصري ” جِيبتك يا عبد المعين تِعينى لِقِيتك يا عبد المعين عايْز تِتْعانْ ” ،
على أن الناقد البصير يدرك بدون أدنى صعوبة الفرق بين هذين المثلين المغربي و المصري ، و حتى لا يفهم كلامي على نحو خاطئ ، أجدنا مضطرا إلى التأكيد على أنني لا أقارن بين الأمثال المغربية و الأمثال المصرية في عمومها ، و لكنني بصدد توضيح ما بين هذين المثلين من فوارق في تقديم مضمون يكاد يكون واحدا و هو ” لا تنتظر أن يساعدك من يحتاج هو نفسه إلى المساعدة ” .
الخوخ فاكهة صيفية بامتياز ، ميزته سرعة فساده و تلفه ، فهو لا يصبر مثل التفاح خاصة إذا أصابه البلل ، و قد استعارت الذاكرة الشعبية المغربية هذه الفاكهة التي تحتاج إلى عناية شديدة ، و جعلتها رمزا لتعبر به و من خلاله عن استحالة طلب شيء من فاقده . و لعل لهذا المثل سياقا ، فهو يستعمل حينما يلتجئ الإنسان إلى شخص و هو يأمل أن يجد عنده العون و المساعدة ، لكنه يرجع بخفي حنين ، بل ويتأكد لديه أن ذلك الشخص هو نفسه في حاجة إلى المساعدة .
لقد استعارت الذاكرة الشعبية المغربية عناصر هذا المثل من الطبيعة ” الخوخ ” و اعتمدت في تصوير المعنى ” عدم النفع ” على ما تراه العين حقيقة من فساد الخوخ و سرعة تلفه ، و هو معنى حسي يصور تصويرا بليغا المعنى الذي سيق له .
على أن المثل المغربي فيه موسيقى و إيقاع داخليان يتجليان في تكرار حروف بذاتها “تكرار حرف الكاف ثلاث مرات ” و تكرار ” كون كان ” مرتين ، و كلمة ” يداوي” مرتين . و لا يخفى ما في المثل المغربي من إيحاء مستمد من الرمز و كثافة في التعبير ، و امتداد أفقي و عمودي ، إذ يمكن بكل سهولة إسقاط المعنى المستبطن على سياقات شتى ، و وضعيات متماثلة سواء تعلق الأمر بالمتكلم أو المخاطب ، فكلاهما يمكنه توظيف المثل متحدثا عن نفسه أو متحدثا عن غيره . هذا المثل باختصار شديد تشخيص لمعنى عقلي في صورة حسية مستمدة من واقع ملموس .
- النموذج الثاني : ” الِّلي يِتْصاحَبْ مع الكَرَّابْ يِتْصاحَبْ مْعاهْ في الَّليالِي “
ولنقف قليلا عند مفردات المثل : “اللي ” تعني الذي ، و ” الكراب ” تعني السقاء الذي يحمل على ظهره قربة من جلد الماعز في الغالب مملوءة بالماء ، و ” الليالي ” عند المغاربة هي أشد أيام فصل الشتاء برودة ، و تمتد من الخامس و العشرين من الشهر الأخير من السنة الميلادية (25 دجنبر ) إلى اليوم الثاني من الشهر الثاني ( 2 فبراير ) ، وهي أربعينية فصل الشتاء المعروفة بقساوة الطقس و برودته ، و للمغاربة فيها طقوس و عادات فلاحية و اجتماعية ، في مأكلهم و ملبسهم ، يتقون بها نوازل برد الأربيعين ليلة ولفح زمهريرها .
و من وجباتهم المعتادة في هذه الأيام ، تحضير الكسكس بسبعة أنواع من الخضروات الموسمية ، لحاجتهم إلى مأكولات ساخنة خاصة بالليل ، و احتشاء الشاي بالشويلاء ” الشيبة عند المغاربة ” .
و لا يكتفي المغاربة بذلك ، بل يحرصون على ارتداء الجلابيب الصوفية التي تحمي من لسعات البرد . و لست هنا بصدد عد و إحصاء عاداتهم في المأكل و المشرب و الملبس ، فكثير من تلك العادات واراها النسيان في ظل التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي خاصة في المدن الكبرى ، لكنها لا تزال تحافظ على وجودها في مناطق الأطلس ، حيث تتساقط الثلوج بكثافة حتى لكأن هذه الجنة من بلاد المغرب بقعة اقتطعت من أوروبا ، و في البوادي و الأرياف حيث لا يزال الناس في منأى عن زخرف المدنية الزائف .
وفي ظل هذه الأجواء الزمهريرية نسجت الذاكرة الشعبية أمثالا و حكما أخرى ذات صلة بهذه الليالي منها على سبيل المثال : ” ” إِيلَى رْواتْ فِ الليالي عَوَّلْ على السمن بِ لَقْلالي”، و معناه إذا ارتوت الأرض بالماء في الليالي فسيفيض الخير و يكثر السمن و يحتاج إلى عدة قُلَلٍ لحفظه .
و يقسم المغاربة الليالي إلى ” ليالي مسعودة ” و ” ليالي غير مسعودة ” ، ولأن المغاربة بطبعهم متفائلون ، فأفضل الليالي عندهم هي ما كان الغيث ينزل فيها بالليل دون النهار ، لحاجتهم إلى الشمس بالنهار لمباشرة أعمالهم و قضاء حاجاتهم ، و هو ما عبروا عنه بالمثل التالي ” الليالي المسعودة تَنْزَلْ الشتا بالليل والنهار مفقودة “ ، و المقصود بالشتاء في ثقافتنا الشعبية المطر .
و في ظل هذه الأجواء التي يبتهج بها الفلاحون ، هناك شخص تتعطل حركته و تنغلق في وجهه سبل تحصيل الرزق ، إلا ما كان قد حصله من قبل ، فقد كسدت بضاعته ولم يعد أحد يشتري منه الماء ، ذلكم الشخص هو ” الكراب ” أي السقاء ،
و لنعد مرة أخرى إلى المثل الذي انطلقت منه : ” الِّلي يِتْصاحَبْ مع الكَرَّابْ يِتْصاحَبْ مْعاهْ في الَّليالِي ” . و أعتقد أنه بعد هذا البيان أصبح معنى المثل واضحا ، فالسقاء ” الكَرَّابْ ” لا يحتاج إلى الأصحاب في وقت الصيف لحاجتهم إلى مائه و هم يتلظون عطشا ، فحاجتهم إلى الماء تغنيه عن مصاحبتهم ، لكنه في ظل أجواء الليالي حيث لا يحتاج ماءه أحد يكون في مسيس الحاجة لمن يقدم له يد المساعدة و يحسن إليه ، إذ هو ملهوف في حاجة إلى الإغاثة ، و كما قيل ، فالصديق وقت الضيق .
و لعل المغاربة يضربون هذا المثل للصديق أو الشخص العزيز الذي كنت تأمل منه مساعدة وقت حاجتك إليه و هو قادر على تقديمها ، لكنه يَقْلِبُ لكَ ظَهْرَ الـمِجَنِّ ، فيتعامى عن رؤيتك و يتصامم عن سماعك ، فتجده يحرص على مودتك ساعة يسرك ، و يتجافى عنك ساعة عسرك .
و أخيرا فإنه لا يخفى ما في المثل من توظيف للرمز ، فَ ” الليالي ” ترمز للشدائد و المحن التي يكابدها الإنسان كما هو الحال في كل جنبات الأرض ، و ما مصاب غزة المنكوبة اليوم عنا ببعيد ، و ” الكَرَّابْ ” رمز للملهوف كما هو حال المنكوبين هناك ، الذين باتوا يفترشون الأرض و يلتحفون السماء يتربص بهم عدو قلب ظهر المجن لكل القيم الإنسانية النبيلة ،
على أن اقتران الكلمتين ” الليالي و الكراب ” في سياق واحد يجعلك تشعر بزمهرير فصل الشتاء و تستشعر حاجة كل ملهوف في بلاد الله الواسعة إلى ما يخفف عنه ما ألم به ، مما يستجيش فيك المبادرة إلى الإحسان قبل أن يُطلب منك .